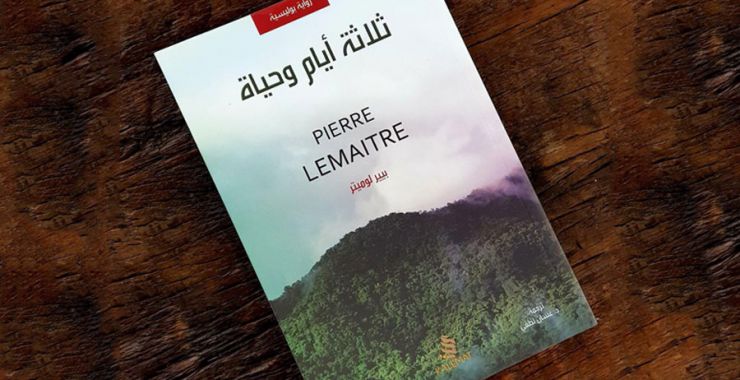
ويعد “بيير لوميتر” كاتب فرنسي من أهم كتاب الرواية البوليسية، حتى إن الكبير “ستيفن كينج” قد أثني عليه أحسن الثناء فوصفه بأنه من كتاب رواية التشويق الممتازين. هو حاصل أيضًا على جائزة “غونكور” -أهم جوائز فرنسا- سنة 2013.
وقد ترجمت رواياته إلى لغات عديدة ليس من بينها العربية للأسف. إذًا “ثلاثة أيام وحياة” هي أول رواية له تنقل للعربية، حيث صدرت عن “دار كلمات للنشر” سنة 2017 بعد عام واحد من نشرها في فرنسا، بترجمة “غسان لطفي” الذي قدم للرواية بنبذة مخصرة عن محتواها وكاتبها والترجمة.
ثلاثة أيام وحياة: ليست بوليسية تمامًا
الشخصيات ليست أكثر العناصر أهمية في الرواية البوليسية. معروفٌ أن قارئ الأدب التشويقي يبحث في الأساس عن الفكرة المحمِّسة واللغز المثير وبالطبع النهاية المفاجئة، والشخصيات في هذا السياق عامل مكمل مهم لكن غير محوري. حتى القصص التي تقودها الشخصيات وتحكم تحولاتِها تحولاتُهم فإنها تظل تعتمد أساسًا على قدرة الكاتب على إبهار القارئ.
آخر رواية بوليسية قرأتها تدعى “نحن الكذابون”، وبرغم النهاية المستهلكة إلا أن مناسبتها للسياق ومجانبتها للتوقع رفعت نظرتي العامة للرواية. أذكرها لأنه برغم الشخصيات المرسومة بالحد الأدنى من الإتقان فإنه قد بلغني هذا الشعور الذي تصدره الروايات البوليسية: أن كل الشخصيات متشابهة والتنويع عليها إنما يجري في نطاق محدود.
يختلف هذا طبعًا من كاتب إلى آخر وهو محكوم بقدرة الأديب على التعبير، لكنه في البداية محكوم بقالب الأدب البوليسي الذي إذا وضع القصة في المركز همّش بالتالي -دومًا- الشخصيات، فتتحول من حاملة إلى محمولة.
“ثلاثة أيام وحياة” للكاتب “بيير لوميتر” ليست من هذا النوع بالضبط لسبب بسيط هو أنها بوليسية من غير لغز. الفكرة مسلية بالنسبة لي من الأساس: ماذا لو أخذنا كل الذي تعبر عنه الرواية البوليسية ووضعناه في سياق آخر بنزع اللغز عنه؟ القاتل هنا معروف من البداية، والأحداث كلها تجري حوله ومن زاويته.
فعَل هذا أشياءَ بالنص أهمُّها -استكمالًا لما قدّمنا به- وضع الشخصية في المنتصف مع بقاء الجو العام المميز لهذه النوعية وتوافر كل مقوماتها: الشرطة ضعيفة الإمكانات الباحثة عن الحقيقة، القرية الصغيرة التي ينقلب حالها وتتغير حيوات آلها وتتكشف أسرارها وعللها وتخرج للسطح أحشاؤها، عائلة القتيل ومأساتهم الطويلة ومصائرهم، تدخل الإعلام وصورة ذلك وأثره.
إخراج اللغز من المعادلة أتاح لنا التركيز على الشخصيات، بخاصة “أنطوان”، من دون التهاء بانتظار الكشف وتحميل الحوارات والمواقف معاني خفية والتساؤل المستمر عن النهاية، وبالطبع رؤية الشخوص كلهم بعيني الاتهام دون قضاء أقل الوقت في فهم ظروفهم ودوافعهم.
الحدث الكبير
هذا نص أنصفته الترجمة. مترجم “ثلاثة أيام وحياة” متأثر بأسلوب القرآن الكريم، وطريقته تعطي انطباعًا بحرصه -كما قال في المقدمة- على التزام روح النص وتفادي صبغه بروحه هو وفهمه إلى الحد الأدنى.
كثير من الأعمال التي تنغمس في وصف عالمها تنتهي إلى صورة مستغلقة يعجز القارئ عن النفاذ إليها. لكن في “ثلاثة أيام وحياة” ترى بوضوح اهتمام الكاتب بإنتاج نص يسهل أن يكون عالميًّا، مشاهد ومواقف يمكن أن ينتمي إليها القراء على اختلاف مواضعهم من العالم وطرق رؤيتهم للأمور.
ولأن تصنيف الرواية معلوم، إذ هي صادرة عن كاتب يكتب أدب التشويق، وقد تطوعت الدار المترجمة وصرحت على الغلاف بنوع النص، فإن الصفحات الأولى، المكتوبة بأسلوب هو نفسه مثير للاهتمام، ترفع الفضول للحدث المثير المتوقع والذي جرى ذكره في الصفحة الأولى. لا تنس أن الروايات البوليسية تركز أيضًا على البداية اللافتة التي تجذب القارئ من النظرة الأولى، وما هذا إلا لأن معظم الأدب البوليسي -خاصة نوعية “من فعلها”- لا تعدو أن تكون انتظارًا طويلًا للنهاية تتخلله بعض المحفزات التي تختلف درجة قوتها.
الحدث هنا موت الطفل ذي الأعوام الستة. والمرء يحب -خاصة في قراءته الأدب- النظر للأحداث المهمة من حيث ما أدت إليه، وهذا يستعمل هنا على أفضل صورة، حتى إن الملاحظات التي آخذها عادة على هامش قراءتي للرواية مكتوبة بخط عجول رديء هو أثر رغبتي في العودة إلى الصفحات المنطلقة بسرعة، ومتابعة تقدم الأحداث ومسار شخصية “أنطوان” الذي لا أدري متى تسلل إلى دائرة اهتمامي.
لحظة واحدة
الأدب المكتوب عن الأطفال أقل ما في أنواع الأدب تأثيرًا بي، وأنا لنزوعي للتعميق غير الضروري أعزو ذلك لعدم صدقه. احتملني لحظة: يصدر الأدب عن أصحابه في كثير من صوره، فالكاتب يكتب عن نفسه في الشباب والكهولة والكبَر، والمرأة تكتب عن نفسها، وأصحاب الوظائف والتوجهات والخبرات يكتبون كلٌ عما يخصه ويعرِّفه، ويبقى لنا الأطفال الذين لا يبلغنا عنهم أبدًا أدب مستحق للنشر والاطلاع. إذًا يكتب الناس منطلقين عن أصل راسخ حاكين الأوضاع من دواخلها، فإذا شرعوا ينسجون حكايات عن الأطفال اتجهوا إلى الذاكرة البعيدة والانطباعات.
لكن الجريمة والمأساة تمنح “ثلاثة أيام وحياة” إمكانية استدرار العطف من القارئ بغض النظر عن كل شيء آخر. الحقيقة أنها حكاية فاطرة للقلب، فيها ما في ظلم الإنسان للإنسان وظلمه لنفسه ما يرهق المتلقي ويعيد له كل مخاوفه عن الصدامات العبثية بين العائشين وأثر ذلك على المدى الطويل الذي قد يشمل حيوات كما يوحي الاسم.
لحظة غضب واحدة، لحظة واحدة مهما حشدتَ لها من الأسباب وأطلت في تأملها، أدت بالطفل “أنطوان” ذي الاثني عشر عامًا إلى توجيه ضربة إلى الطفل “ريمي” ذي الست سنوات قتلته. لحظة واحدة بنَت هذه الرواية، وكان هذا ممكنًا لأنها تقع في الحقيقة وتبني من المآسي والتغيرات ما لا يحصى.
خلال الصفحات التالية نتتبع البحث الشرطي من عيني “أنطوان”، ناظرين إلى أبعد النقاط في أعماقه. لا يفترض بهذا التشريح إشعارك بتعاطف غير محكوم مع القاتل، بل بالقدر الضروري من الفهم للمذنبين، والظروف التي تؤدي للأخطاء وتحف بها بعد وقوعها مع بقاء الاستحقاق للعقاب.
الأمر الثاني أنها تبين لك فعل القتل، كيف هو على شناعته قد يقع على سبيل الخطأ أو شيء بين الخطأ والعمد، وكيف يحدث في ثانية من غير إعداد أو توقع. لهذا -ذكرتُ وأنا أقرأ- نهت الشريعة عن مجرد إشارة المرء لأخيه بحديدة (ليس هذا محل التفصيل لكن الاطلاع على أحكام القتل الشرعية العبقرية تضفي نكهة استثنائية على قراءة أدب الجريمة ومشاهدة أفلامه، والأهم أنها تقي من الأفكار المعلّبة المتصلة بهذا الفن والموضوعة باختزال تحت كلمة مطاطة هي الإنسانية).
أفضل الخيارات
عند التدقيق في فكرة السجن المعاصر، ترى بوضوح أن الخيار الذي نطرحه للمجرمين والقتلة لن يبدو عادلًا للمذنب مهما عظم ذنبه (مثال ذلك في الرواية خوف “أنطوان” من التعرض للاعتداء الجنسي في السجن -والذي كان سيحدث له على الأرجح- لِما شاهد في أحد المسلسلات الأمريكية). فالبطل هنا يجمع بين الخوف من العقاب الذي يعلم أنه يستحق، وبين الحرص على وقاية نفسه من ظلم يفوق احتماله ولا يستحقه وينتظره قطعًا لأن المجتمع -كما نعلم وكما توضح الرواية- عاطفي أحمق يهتم بإشباع الرغبة في الانتقام أكثر من اهتمامه بالعدل، كما أنه يستخدم الاستقباح للجرائم وسيلة دفاعية يُبعد بها عن نفسه الخوف من مصائب هو معرض لها على الدوام بحكم العيش.
بات “أنطوان” مجبرًا إذًا على مشاهدة كرة ثلجه تتعاظم وتتضخم وتسبب كل الأضرار الممكنة، حتى يجد نفسه يقارن بين تراكم هذا القبح وبين التخلي عن غريزته والسماح لآخرين بمعاقبته. أعتقد أن أصعب جزء في الأمر معرفة المرء قيمة نفسه الحقيقية، في مقابل إدراكه لتمسكه الحقير بالحياة.
أفضل خيارات الوضع المتشابك الذي أحكمه “بيير لوميتر” في “ثلاثة أيام وحياة” (والتي ظلت حتى النفس الأخيرة محتفظة بمقدرة على الإدهاش) هو الكتمان، وما ينتج عنه من عيش في الخوف، ومراقبة تداعيات خطيئته، والسماح لشعوره بالذنب بالنمو، والعجز المميت عن طلب عون من أي نوع، واتساع مناطق الشك ولوم النفس. لو لم يكن هذا كافيًا فإن الكاتب يقفز بنا للأمام، على مرتين، أكثر من خمسة عشر عامًا، ليرينا كيف أن أشياء من هذا النوع لا تنتهي أبدًا.
