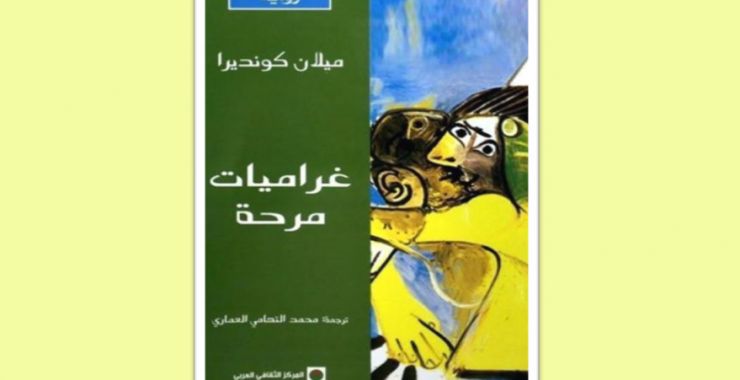
لعبة الأوتوستوب: واحدة من غراميات تبدو مرحة
من بين مشاعر الناس كلها، يحظى الحب الواقع بين الجنسين بترويج عظيم التحيز، يُغفل عيوبه التي هي امتداد لعيوب الإنسان وقدرته على التواصل. من حسن الحظ أن استخفاف “كونديرا” بالناس والحياة امتد للاستخفاف بالحب. لا أمجّد الاستخفاف لذاته بل لأنه مدخل ممتاز للتفكير المنطقي.
ففي مقابل نوع كامل من الأدب -إن تجوزنا فسميناه أدبًا- يحفل بتجميل صورة الحب، وتنقيته من الشوائب، وتنميط صوره على نحو يفقدها حضورها الواقعي ويمنحها ما يرغب فيه كتاب الرومانسية بالضبط: إنشاء عالم مواز مكذوب يتمتع بناس مكذوبين يتبادلون حبًّا لا يُرى في العالم الحقيقي. في مقابل هذا يقتطع “كونديرا” مشهدًا من حياة شخصين عشوائيين، في تجرد كامل عن التنميق وإخلاص للغوص في النفس البشرية، ومن دون تحرج من إبداء ما يسفر عنه هذا الغوض وإن قَبُح.
الفكرة أن الواقع لن يعاني في محاكاة هذا القبح الذي تعبر عنه “لعبة الأوتوستوب” وبقية قصص “غراميات مرحة” وسواها مما كتب “كونديرا”، فإن الناس في الحقيقة يواجهون مثل هذا وأسوأ منه دون أن ينتفعوا منه بشيء في تصورهم العام عن الحب وتبجيلهم غير المخلوط بنقد له.
يُكتب الأدب لإزاحة الواقع عنك وإزاحتك عنه، وإذا كان الأحرى في بعض الأحيان أن يكون هذا الواقع البديل مغايرًا للأول، سامحًا بالتنفس والابتهاج، ففي أحيان أخرى يكون الأحسن تناسق البديل مع الأصلي، بحيث يمكن الاستعانة بهذه الصور المتخيلة، والتي يجعلها إتقان كاتب ببراعة “ميلان كونديرا” قابلة للتصديق، أو قابلة للاشتراء بغض النظر عن التصرف الملائم بها من بعد.
فكرة الاتصال التي يعبر عنها الحب مخيفة من حيث الأصل، إذ هي أكثر الأشياء تهديدًا لاستقلال المرء، لهذا فإن معظم خلافات المحبين تصب في دائرة مقاومة الإنسان الطبيعية للاندماج التام الذي يعبر عنه الحب. هذا على سبيل المثال أحد الجوانب منزوعة الرومانسية التي توفر نظرة أشمل على فكرة الحب، والتي لا تلائم بالتالي قصص العشق الاعتيادية.
المبالغة
ولماذا لا نمجّد الحب؟ الحق أن وصف الحب المجرد هذا لا وجود له في الواقع، وأننا في الحقيقة إنما نتعامل مع شكله الذي يتخذه إذا احتوته أوعية البشر. أقول إذًا إننا في الحب، كما في غيره، لا نبغي سوى فهم الناس وسلوكياتهم، وهو بالضبط ما تستطيع الخروج به من “لعبة الأوتوستوب” إن أنت أصخت السمع لـ “كونديرا”.
أجمل ما في القصة أنها -وهي مزية تخص القصص القصيرة دون سائر صور الكتابة- مذهلة في تعبيرها عن “كونديرا” نفسه، فهذه الجرعة الصغيرة تلخص فلسفة وطريقة الرجل على نحو غير متوقع. شاهده وهو ينتزع من الحياة قطعة، يشدّها بلا رفق ويعتصرها فتنزّ مشاكلها، ثم إذا هو يلزم أشد الطرق تطرفًا في التعبير عن هذا المشاكل، فلا طريقة أفضل لبلوغ القاع من المبالغة. يأخذ حلمًا طفوليًّا ويعرضه بنوع من السادية في سياق واقعي كابوسي مقزز.
مبالغة “كونديرا” في تتبع منابع الأفعال هي بناء على الأصل الذي تعبر عنه الكتابة، وهو تطوير وتضعيف الخيالات حتى تستوي على هيئة حيوات. عندما أتصور العملية -التي أختبرها غِبًّا باعتباري كاتبًا- يسرني التفكير في أن هذه التصاعدات فاجأت كونديرا نفسه، وأوصلته إلى مرحلة الاسترسال مع سيلان الأفكار بعدما تكلّف البذرة الأولى.
أدق التفاصيل
قصة “لعبة الأوتوستوب” من “غراميات مرحة” تحكي باختصار عن شاب وشابة في طريقهما بالسيارة لقضاء عطلة. تبدأ المأساة بشروع أحدهما في لعبة تقمّص عفوية؛ اللعبة التي تراها في الأفلام في مزاح المتحابين. لكن لأن الأصل واهٍ فإن اللعبة تفعل الشيء الوحيد غير المنتظَر من لعبة: تصبغ الأمر كله بجدية استكشافية تفضح للواحد منهما كل سوء في نفسه والآخر.
كنت أكلم صاحبي قبل أيام، في لحظة تأمل رفاهيّة، عن الجانب الإبداعي المغفول عنه في الرسم، وكيف يحدث أن تتغير الصور بشكل تام، فضلًا عن تغير الانطباع الذي تمنحه، تبعًا لتغير أدق التفاصيل. قلت في نفسي إن هذا عائد إلى أن هذه التفاصيل الدقيقة كانت المسؤولة عن الانطباع الأول أيضًا. يخطر ببالي الآن أن هذا بالتحديد ما حدث في القصة: عدد صغير من التغيُّرات قوّض هذا البناء الآيل للسقوط أصلًا، والذي بدا حتى اللحظة الأخيرة متماسكًا.
لا يبذل الناس في تقوية العلاقات البشرية الكثير، غافلين عن أنها في الأصل -لمتعدد الأسباب- مليئة بنقاط الضعف التي قد ينتج انكسار عن أي ضغط عليها، معوّلين أكثر من اللازم على الحظ وملتحفين بأمل ماتع أحمق. الأسوأ أنهم لا يكادون يبذلون الجهد في تطوير ذواتهم وجعلها أحسن عشرة وأجدر بمقاومة ما تبتلي به الحياةُ قاطنيها.
بالعودة إلى ما بدأته سابقًا، أقول إن تفصيل هذا الانهيار في قصة “لعبة الأوتوستوب” لـ “ميلان كونديرا” قد يكون آتيًّا من الاستعراض، سأفهم هذا وأتقبله لأنه لا ملزم للكاتب أن يكتب أصلًا، ولأنني لا أبالي بالمصدر ما دام قد تولّد منه إبداع جدير بالاحترام. لكن المهم أن هذا الانهيار داعٍ للنظر في الأسباب والنتائج، والتي تدور كلها في فلك العلاقات الهزيلة المبنية على أسوأ الأسباب والمشدودة بخيط استمرارية القصور الذاتي الدقيق.
ضوضاء
“سرعان ما اتخذت اللعبة طابعًا جديدًا… وهكذا طغى الوجود التمثيلي على الوجود الواقعي. كان الشاب يبتعد في الوقت نفسه عن ذاته وعن الطريق الصارم الذي لم يسبق له قط أن حاد عنه”.
يمكن لـ “كونديرا” أن يكون مخيفًا، يمكن له أن يتجاهل قدرة القارئ على التحمل ويعرض من خلال قصة (يعني بمواربة شكلية مهينة) هول ما يمكن للمرء اكتشافه عن نفسه -ثم عن غيره- عند الخروج من ذاته للحظة واحدة. ألهذا يبدو الناس مستمسكين جدًّا بذواتهم وآرائهم وعاداتهم؟ إنه الخوف من رؤية الحقائق وما سينبني على ذلك من حاجات. بالأمس كنت أشاهد مسلسلًا بريطانيًّا عن الجاسوسية اسمه “Deep State”، وقد سمعت غير قائل يؤكد أن الحقيقة لم تعد تهم أحدًا، مجرد ضوضاء لا قيمة لها.
هل نحب الأشخاص لأجل ما هم عليه، أم لأجل صور موازية اقتبسناها في أذهاننا عنهم وشرعنا نحشد لها الولاء؟ أيهما الأصل: المعشوق الواقعي أم المواصفات القياسية التي نسميها فارس الأحلام وما شابه؟ وماذا لو أنه جرى ما يجري في العادة فعرفنا أن البون بين المأمول والموجود أوسع من أن يُحتمل؟ أنُدشّن بحثًا جديدًا أم نرضى بالمقسوم؟ وإذا رضينا، أيكون هذا بالقبول غير المشروط أم بخداع النفس وإيهامها بما هو غير كائن؟ هل الطرف الآخر في العلاقة جذري أصلًا أم أنه كيان مبهم الملامح يسهل استبداله بلا أضرار؟
وإذا كان كل هذا الفساد وارد الحدوث في حالة بطلينا الواعيين بنفسيهما، أي قدر من الكوارث يمكن أن يقع في مجتمع قليل الإدراك لعيوبه يحسب أن تجاهل المشاكل يُذهبها؟
تجرُّد
“كان لا يزال أمامهما ثلاثة عشر يومًا”.
التقمص تحررٌ لا من الحياة فحسب، بل من النفس أيضًا. من شخصية تلبسك وماضٍ يلاحقك ومرجعيات وآراء تحدّك وتوجه سهمك إلى مستقبل معين. كأن “كونديرا” خطّ “لعبة الأوتوستوب” ليسأل: هل يمكن أن يراك شخص على هذه الدرجة من التعري (وإن يكن هو نفسه عاريًا كوليد) ثم يظل محتفظًا بحبه واحترامه لك؟
لا يمكن أن يوجد تجسيد أجود لمشاكل علاقة ما من تخلي طرفيها عن موضعَيهما والتظاهر بكونهما غريبَين تمامًا، سامحَين لكل احتمال عشوائي بالدخول بينهما، مدفوعَين بالفضول إلى معرفة الحد وتلذذٍ مريضٍ بالتدمير بعد البناء، بالتظاهر والخروج عن العادة والقوالب المحفوظة والاحتمالات المتصلبة الحاكمة ليوم بعد يوم، بمراقبة الطرف الآخر بوضوح عينين جديدتين كليًّا.
لكن التقمص لا يكون كاملًا أبدًا، والكذب أضعف من أن يملأ الثغرات، وهذا يؤدي إلى النهاية التعيسة: انحباس أحدهما مع الآخر، وتحول الرفقة المطلوبة إلى جحيم سرمدي هو الوجه الآخر للحب، يصوره “كونديرا” ببراعة في ختام “لعبة الأوتوستوب”: مواجهة ذاتك في عينَي آخر رأى منك ما لعلك لم تره من نفسك.
